تقديم نظرية "حق المواطنين في الأمن الأخلاقي" من قِبَل الدكتور محسن إسماعيلي في جامعة الدفاع الوطني العليا

في إطار احتفالية مرموقة شهدتها أروقة جامعة الدفاع الوطني العليا يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر، وبحضور نخبة من كبار القادة العسكريين والمسؤولين المدنيين، أُقيمت مراسم إحياء أسبوع البحث العلمي والكشف عن النظريات المتميزة، وفقاً لما أفاد به مركز الاتصالات والعلاقات الدولية.
وقد برزت من بين النظريات المرموقة التي حظيت بتقدير خاص "نظرية الحق السيادي للمواطنين في الأمن الأخلاقي"، التي قدّمها المفكر البارز الدكتور محسن إسماعيلي. وفيما يلي النص الكامل لشرحه الوافي لهذه النظرية المتميزة بعمقها الفكري وشموليتها المنهجية:
بسم الله الرحمن الرحيم
إننا نؤكد، وبكل ثقة واقتدار، أننا أتباع منهج رباني شامل ودين سماوي متكامل، يستجيب لكافة احتياجات البشرية في شتى الأزمنة والأمكنة. فمنذ قرون عديدة، تبلورت قاعدة أساسية راسخة في الفكر الإسلامي، أقرّها علماء الكلام المسلمون، ثم أكدها الأصوليون والفقهاء، مفادها أنه "لا يمكن أن تخلو أي واقعة من الوقائع الإنسانية من حكم شرعي في الإسلام". غير أن هذه الحقيقة الجوهرية لم تُقدَّم بالأسلوب الذي يليق بعظمتها وأهميتها.
إن ثمة فارقاً جوهرياً بين امتلاك الرؤية وفن تقديمها، وبين حقيقة الثبوت ومهارة الإثبات. فلا بد من تحقيق التناغم المثالي بين جوهر الفكرة وأسلوب عرضها. والواقع أن الغرب المعاصر، رغم ما يشوبه من نواقص وعيوب، قد نجح في فن العرض والتقديم بصورة تفوق ما حققناه. أما نحن المسلمين، فقد عانينا تاريخياً من قصور في آليات تقديم وإثبات مخزوننا الفكري والعلمي الثري.
ولم يقتصر الأمر على مجرد العجز عن العرض المثالي لما نملك من رؤى وأفكار، بل تجاوزه - للأسف الشديد - إلى الوقوع في مزالق سوء التقدير وضعف الرؤية الإستراتيجية، مما ألحق أفدح الأضرار بمنظومتنا الدينية وهويتنا الوطنية وموروثنا الثقافي.
ولإدراك عمق تداعيات هذه المعضلة التاريخية، يكفي الاطلاع على ما سطره العلامة الشهيد مرتضى مطهري في مؤلفه القيم "علل الميل إلى المادية"، حيث يكشف بجلاء كيف أن التقديم المعيب وغير المدروس للمفاهيم الدينية، قد أسهم بشكل مباشر في تنامي ظاهرة النفور من الدين، بل وتطورها إلى حد العداء السافر له. ويؤكد الشهيد مطهري، بشجاعة فكرية وصراحة علمية، أن مسؤولية المسلمين وعلمائهم في نشوء وانتشار العلمانية عالمياً، لا تقلّ خطورةً عن دور أوروبا والكنيسة.
وللأسف الشديد، استمر هذا القصور حتى في مرحلة ما بعد الثورة، ويتجلى ذلك بوضوح في عدم قدرتنا على التبيين والعرض الحكيم والسليم للمفاهيم والنظريات العديدة والرائدة التي طرحها القائد الأعلى للثورة، بصفته عالماً دينياً بارزاً وخبيراً في الشؤون الثقافية، على مدى السنوات الماضية. فمعظم هذه الأفكار لم تُقدَّم بالشكل المناسب بسبب هذا الضعف التاريخي المتأصل.
ومن بين هذه المفاهيم والأفكار الجوهرية مصطلح "الأمن الأخلاقي" الذي طرحه سماحته في أكتوبر 2003، معتبراً إياه أحد الواجبات السيادية للدولة. ومنذ ذلك الحين، وللأسف، لم يُبذل أي جهد علمي جاد ومنهجي لتطوير هذه النظرية. بل على العكس، أدى اختزالها في بعض التطبيقات الثانوية وتنفيذها بشكل غير سليم، إلى فهم مجتزأ مهّد الطريق للتشكيك في أصل الفكرة. وقد أُثيرت أحياناً شبهات ذات مظهر علمي، لكنها نابعة في الحقيقة من إشكاليات تطبيقية، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى وصفها بالبدعة العلمية، مدعين وجود تناقض داخلي في مفهوم "الأمن الأخلاقي" متسائلين: هل يمكن الجمع بين الأمن والأخلاق؟!
وأودّ هنا أن أتقدم بالشكر والتقدير لصديقنا القديم اللواء هداية لطفيان، الذي كان السبب في إثارة مثل هذه المباحث في ذهني. ففي عام 1998، حين كان قائداً للشرطة، سألني عما إذا كان لدينا ما يسمى "بالفقه الشرطي". هذا السؤال دفعني لكتابة مقال نُشر لاحقاً بعنوان "الأمن والشريعة". ومنذ ذلك الحين، بدأت هذه الدراسات، وساعدت التجارب العملية في تطويرها، حتى تم العام الماضي صياغة وإثبات النتائج العلمية والتجريبية في صورة نظرية متكاملة.
إن إثبات هذه النظرية، يمكن أن يسهم في الصياغة النهائية للمذهب الأمني الشيعي أو المذهب الأمني الإسلامي، لنطرحه في مواجهة المذاهب الأمنية المختلفة المطروحة عالمياً. وأشير هنا إلى أنني أتغاضى عمداً عن التفريق بين النظرية والمذهب في هذا السياق.
کما أن المذاهب الأمنية المعاصرة التي نطلع عليها ونشهدها في عالمنا اليوم، إما أنها أغفلت البُعد النفسي للأمن تماماً، أو أنها منحته دوراً ثانوياً هامشياً. بيد أن نظريتنا تؤكد أن البُعد الذهني والثقافي للأمن لا يتمتع بالأصالة فحسب، بل يمكن القول إنه وحده ما يمتلك هذه الأصالة. وهذا ما تؤيده الآيات القرآنية والروايات واستنباطات فقهائنا، وقد أوردتُ دلائل ذلك في متن البحث. وهذا يمثّل نقطة تمايز جوهريةً بين نظريتنا والمذاهب الأمنية العالمية التي تركز على البُعد المادي الملموس.
ومن النقاط المحورية التي تناولتها في هذه النظرية، أن مفهوم الأمن الأخلاقي لا يتعارض مع مبادئ وأصول القانون الدولي فحسب، بل يتوافق معها تماماً. وقد خصصت جزءاً كبيراً من البحث لإثبات أن وصف هذه الرؤية بالبدعة، ينبع من عدم الإلمام بأسسها العلمية.
وعلى الرغم من أننا لا نسعى لجعل معايير وأحكام العالم الغربي مقياساً لتقييم معتقداتنا، إلا أننا نؤكد أن نظرياتنا أكثر قابليةً للدفاع والتطبيق حتى وفقاً لتلك المعايير ذاتها. وعلى هذا الأساس، تم تقديم وإثبات النظرية الحالية بفضل الله. لكن الأهم هو الانتباه إلى نتائجها وتحذيراتها وحلولها المقترحة.
وأرى من الضروري الإشارة بشكل خاص إلى أن مصطلح "حق المواطنين في الأمن الثقافي"، قد يكون أكثر ملاءمةً وانسجاماً مع الخطاب العالمي المعاصر. ولكن لأسباب تتعلق بالتوطين ومراعاة المصطلحات السائدة محلياً، فضّلنا استخدام المصطلح الحالي. كما أودّ التأكيد على أن منظومة تعاليمنا الدينية والفقهية، تتضمن جميع المتطلبات الأساسية لتطبيق هذه النظرية وتحقيق الأمن الإسلامي. فقد أولت اهتماماً بالغاً لأولوية التعليم والتربية والأساليب المدنية، وتهيئة الظروف المناسبة لتلبية الاحتياجات الفطرية، وتشجيع الرياضة المجتمعية، والاهتمام بدور الاقتصاد في تحقيق الأمن الأخلاقي. كما تناولت بدقة وعمق تأثير عوامل مثل الفقر، والكسب غير المشروع، والسرقة، والحقد، والمنافسة السلبية وما شابهها في نشوء الانحرافات الثقافية والسلوكية. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ مدى عناية شريعتنا بتحقيق العدالة وتعزيز الثقة العامة بين السلطة والمواطنين لتحقيق هذا الهدف، وكيف وضعت آليات وضمانات غير جزائية متعددة لتحقيقه. وعندما ننظر إلى هذه المنظومة بشكل متكامل، نجد أنها كفيلة بدحض كافة الشبهات والاعتراضات التي تُثار بدوافع مختلفة في هذا المجال. وأؤكد مجدداً أنه لا ينبغي اختزال هذه النظرية السامية في مجرد مواجهة عشوائية مع مظاهر سطحية وانحرافات سلوكية، قد تكون نتيجةً لعوامل متعددة.
وأختتم حديثي بالمقولة الحكيمة للشهيد مطهري، الذي استلهمنا من فكره في مواضع كثيرة من هذه النظرية. فقد أكد صراحةً أن القضايا الأخلاقية ذات طبيعة ثقافية لا يمكن تحقيقها بلغة القوة والإجبار والتسلط. فطبيعة القضايا الأخلاقية والقيمية لا تتحقق بأدوات القوة والضغط، كما أنها لا تزول بهما. نعم، الصلة بين الجانبين ليست منقطعةً تماماً، وقد نحتاج في حالات معينة إلى استخدام الضمانات التنفيذية الحكومية لتأمين الأخلاق الثقافية، لكن ذلك يقتصر على حالات نادرة واستثنائية، ويتم حصراً عبر القوى الرسمية للدولة. وعليه، فإن هذه النظرية لا تمت بصلة لبعض الممارسات السطحية الشعاراتية، وأحياناً المشبوهة، في هذا المجال.
وكما أوضحت في مخطط النظرية، فإننا بعد إثبات هذه النظرية ونجاحها، نحتاج الآن إلى وضع آليات تحقيقها للوصول إلى أهدافها، وتحديد مسؤوليات المؤسسات المختلفة. فالاعتقاد بأن قوات الشرطة وحدها مسؤولة عن هذه المهمة، يتنافى مع جميع الأسس الفكرية. وكما ورد في الوثيقة المعتمدة من المجلس الأعلى للثورة الثقافية، هناك ما لا يقل عن 29 مؤسسة ثقافية وشبه ثقافية مسؤولة عن تحقيق أهداف هذه النظرية، تأتي قوات الشرطة والسلطة القضائية في آخر قائمتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
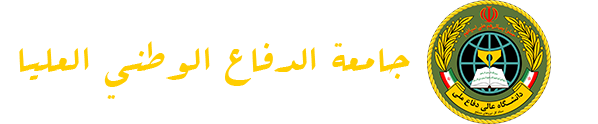


تعليقكم :